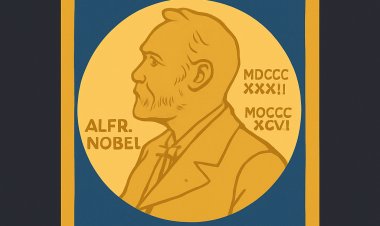القيادة التي تُصغي للتغيير: بين الممانعة والرؤية
تحليل عميق لدور التغيير في استدامة المؤسسات، يوضح مخاطره وفوائده، ويستعرض المراحل والممارسات التي تجعل منه أداة استراتيجية لتعزيز الميزة التنافسية وترسيخ ثقافة الابتكار.

في أروقة المؤسسات، حيث تدور عجلة الاجتماعات وتُعاد صياغة التقارير بلا أثر يُذكر، يطل سؤال قلّما يُطرح لكنه يمس جوهر العمل: هل ما نفعله اليوم هو ما يجب أن نفعله غدًا؟ وهل الثبات على منهج واحد يعكس ثقة راسخة، أم يخفي وراء عباءة الاستقرار خوفًا من المجهول؟ إن الجمود الإداري، وإن بدا مريحًا، قد يكون أكثر خطرًا من الفوضى العابرة التي يثيرها التغيير؛ فالمؤسسة التي لا تتغير، لا تنمو، بل تذبل تدريجيًا حتى تفقد قدرتها على المنافسة والبقاء. من هنا، يصبح التغيير ليس خيارًا تنظيميًا إضافيًا، بل ضرورة وجودية تمس جوهر الاستمرارية.
لا يولد التغيير من فراغ، بل من إدراك صادق بأن الواقع الحالي لم يعد كافيًا. قد يأتي الدافع من الخارج: تحولات السوق، تغير توقعات العملاء، أو تقنيات ناشئة تعيد تشكيل بيئة العمل. وقد ينبع من الداخل: رغبة في تحسين الأداء، تجاوز أزمة، أو إعادة تعريف للأدوار والمسؤوليات. في جميع الحالات، التغيير ليس قرارًا إداريًا يُصاغ خلف الأبواب المغلقة، بل استجابة عقلانية لواقع متبدل، وخطوة واعية لصناعة مستقبل أفضل. وكما قال بيتر دراكر: "الطريقة الوحيدة للتنبؤ بالمستقبل هي أن تصنعه."
ومع ذلك، فإن التغيير لا يُستقبل دائمًا بالترحيب. فالممانعة أمر طبيعي، وهي غالبًا انعكاس لقلق مشروع، لا رفض مطلق. الموظف الذي يخشى فقدان مكانته، أو الذي لا يرى وضوحًا في الرؤية الجديدة، أو الذي عايش تجارب تغيير فاشلة، لن يتبنى المسار الجديد ما لم يشعر بالأمان والثقة. هنا تتجلى القيادة الواعية، التي لا تفرض التغيير من أعلى، بل تبنيه مع الفريق، تُشركهم في صياغة الرؤية، وتفتح قنوات الحوار، وتطمئن القلوب قبل أن تصدر القرارات. فالتغيير الحقيقي يُبنى ويُحتضن، لا يُفرض أو يُملى.
ويحدث التغيير الناجح عبر مراحل متدرجة: يبدأ بالإدراك، يليه وضع رؤية واضحة وخطة قابلة للقياس، ثم تهيئة البيئة الداخلية وتدريب الفرق، فالبدء في التنفيذ بخطوات محسوبة، مع متابعة دقيقة وتعديل للمسار عند الحاجة. وفي النهاية، يترسخ التغيير في الثقافة والسلوك المؤسسي، ويُراجع أثره لضمان استدامته. وكما أوضح كورت لوين: "لكي يتغير الناس، يجب أولًا أن ينفصلوا عن القديم، ثم يُعاد تشكيلهم، ثم يثبتوا على الجديد."
لكن حتى مع استكمال هذه المراحل، يبقى السؤال الأهم معلقًا: هل حقق التغيير الأثر المنشود؟ هل تحسنت بيئة العمل؟ هل زادت الإنتاجية؟ هل تعزز انسجام الفريق؟ أم أن ما حدث لم يكن سوى قشرة تنظيمية لم تمس جوهر المؤسسة؟ النتائج قد لا تظهر فورًا، وقد يحتاج التغيير إلى وقت حتى ينضج، لكن ما هو مؤكد أن المؤسسة التي تتقن فن التغيير هي من تمسك بزمام المستقبل، لا تلك التي تكتفي بردود الأفعال.
فالتغيير ليس مشروعًا يُنفذ ثم يُطوى، بل مسار دائم يعيد تشكيل الهوية المؤسسية باستمرار. إنه امتحان مستمر للمرونة، وللشجاعة، وللقدرة على إعادة النظر في المسلمات. والسؤال الذي يبقى: هل نحن مستعدون لاحتضان التغيير كمنهج حياة؟ وهل نملك الجرأة لنُعيد التفكير في كل ما اعتدنا عليه، لنصنع واقعًا أكثر إنسانية وأعلى قدرة على البقاء؟ إن المؤسسات التي تُصغي وتُراجع وتُجدد، هي وحدها التي تصنع المستقبل... لا تلك التي تلاحقه.
أولًا – تكلفة الجمود
الجمود الإداري لا يُقاس فقط بضياع الفرص، بل بما يخلّفه من خسائر غير مرئية. فالمؤسسة التي ترفض التغيير تخلق بيئة عمل راكدة، تنخفض فيها المعنويات، وتزداد فيها البيروقراطية، ويتآكل الإبداع ببطء حتى يصبح من النادر أن يولد حل مبتكر من داخلها. والأسواق لا ترحم المؤسسات التي تتأخر عن مواكبة التحولات، بل تدفعها إلى الهامش، حيث يصبح البقاء معركة يومية بدل أن يكون نتيجة طبيعية للتميز.
ثانيًا – الثقافة كحاضنة للتغيير
أي تغيير، مهما كان مدروسًا، سيفشل إذا لم يجد أرضًا ثقافية خصبة تدعمه. فالثقافة المؤسسية ليست مجرد قيم مكتوبة على جدران المكاتب، بل هي الممارسات اليومية، وطريقة اتخاذ القرار، ونبرة الحوار بين الأفراد. حين تكون الثقافة قائمة على الانفتاح، والمساءلة، والتعلّم المستمر، يصبح التغيير جزءًا من النسيج اليومي، لا حدثًا استثنائيًا. أما إذا كانت الثقافة قائمة على الخوف، أو التمسك بالمألوف، فإن أي تغيير سيُقابل بحائط من المقاومة.
ثالثًا – مستقبل يقوده التعلّم
التغيير الفعّال لا يتوقف عند تنفيذ المبادرات، بل يتحول إلى دورة مستمرة من التعلّم والتجربة. فالمؤسسات التي تتعامل مع التغيير كفرصة للتجريب، وجمع البيانات، واستخلاص الدروس، هي التي تطور قدرتها على التكيّف مع كل ما هو قادم. هذه المؤسسات لا تنتظر الأزمات لتتحرك، بل تبتكر باستمرار، وتبني قدراتها المستقبلية وهي في أوج نجاحها، لا في لحظة تراجعها.
التغيير كميزة تنافسية
في بيئة الأعمال الحديثة، لم يعد التغيير مجرد استجابة للظروف، بل أصبح هو نفسه أداة استراتيجية لبناء ميزة تنافسية. المؤسسات التي تتبنى التغيير كجزء من هويتها لا تنتظر المؤشرات الخارجية لتتحرك، بل تستبق الأحداث، وتعيد تشكيل منتجاتها وخدماتها وهي في قمة نجاحها، لا بعد أن تبدأ في التراجع. هذه القدرة على التغيير الاستباقي تخلق فارقًا جوهريًا بين من يقود السوق ومن يحاول اللحاق به. وفي عالم سريع الإيقاع، يصبح البطء في التغيير نوعًا من المخاطرة التي قد تكلف المؤسسة مكانتها، مهما كانت قوتها في الماضي.